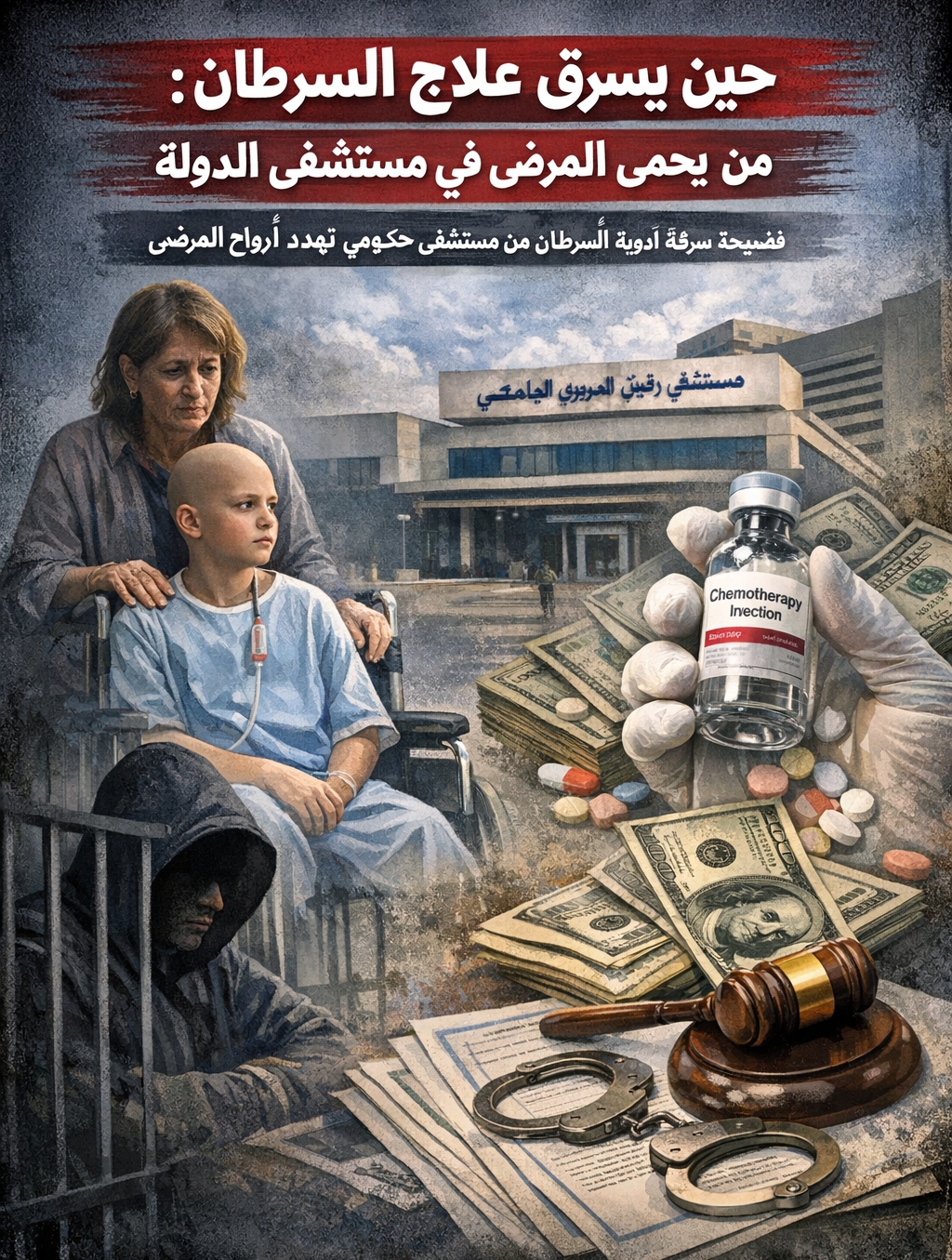خاص "إيست نيوز"
عبير درويش
فكرة "النق" عندنا في لبنان موضوع غنيّ وذو وجاهة كبيرة، لأنها تختبئ خلفها مآسي اجتماعية، أزمات اقتصادية، إرث تاريخي، نفسية مجتمعية وسياسية، بل وتمتد لتكون جزءاً من ثقافة التواصل اليومية. سأحاول عرض المقالة بفصول: تعريف، أسبابه، تجلياته، الأضرار، بعض من الأمل والبدائل، وآراء بعض المثقفين، لنفهم كيف صار "النق" جزء من هويتنا ولماذا؟
ما المقصود بـ “النق”
• "النق" لفظ محلي يعني التذمّر، الشكوى، أو التعبير عن السخط، الانتقاد المتكرر للواقع أو المسؤولين أو الظروف، غالباً بصوت عالٍ، أو عبر مواقع التواصل، أو في الخطاب العام.
• هو ليس مجرد نقد مفيد، بل نقد يرافقه شعور بالعجز غالباً، أو عدم الأمل، رغبة في التنفيس أكثر من البحث عن حل.
كيف وُلد "النق" من وجع الناس في لبنان؟
لبنان مرّ بأزمات تراكمية في السنوات والعقود الماضية:
• الحروب، الاحتلال، الطائفية، الانقسام السياسي
• فقدان الثقة بالمؤسسات: الدولة، القضاء، الإدارة، الخدمات
• الأزمات الاقتصادية: هبوط العملة، غلاء المعيشة، انقطاع الخدمات الأساسية (الكهرباء، الوقود، الدواء)
• النظام السياسي يربط الهوية والطائفية والمناطقية بالانتماء، والمحاسبة غائبة؛
• الفساد والمحسوبيات التي تراكمّت
• ربما أيضاً نوع من "تعلم العجز": عندما تحاول الطبقات الوسطى أو الفقراء أن يناشدوا المسؤول، لا يجدون ردّاً أو تغيّراً.
الإعلام والتكنولوجيا ساعدت: الهواتف، مواقع التواصل، التلفزيون، المساحات التي تتيح للناس أن "تنقّ"، أن تُفصح عما في داخلها.
• البراديغم السياسي: الأحزاب والمجتمع السياسي غالبًا تستخدم الخطاب الشعبوي، الخطاب الاستجدائي، الخطاب القائم على الشعارات — وهذه البيئة تُشجّع على النقّ.
• أيضاً في العائلة والمدرسة والأصدقاء، يُشجّع التذمّر — يقولون “نقّنا شوي لنشوف إنو في حدا سمعنا” — يصبح تقريبًا فنًّا اجتماعيًا.
كل هذا يخلق وجعاً يومياً: تأخّر في إصدار وثيقة، انقطاع كهرباء، دواء مفقود، زحمة أو انهيار مواصلات، أو سوء خدمات عامة. هذا الوجع يكدّس، ويحتاج منفذ للتعبير عنه — فالنق يصبح منفذاً اجتماعياً ونفسيّاً.
أسماء مثقفين/كتاب ماذا قالوا في ظاهرة "النق"!
1 - إبراهيم نصر الله
رغم أنه فلسطيني، أعماله تُلامس الكثير من القضايا المشتركة في لبنان والعالم العربي من حيث التذمّر من الواقع، من الفساد، من السلطة، من غياب العدالة. وفي في حوار معه قال إن السياسة تعامل الكتاب كأنهم نقيض مطلق لها، وأنه عندما يرفض الكاتب “التدجّين” — أي أن يُمسك لسانه أمام السلطة أو الرقيب — يُلاحَق أو يُسكت. وروايته “عو” (1990) تناولت فكرة أن المواطن يُعامل كوعاء فارغ من السلطة، مجبول لإعادة إنتاج خطاب مهيأ بدون أن تكون لديه قيمة حقيقية في القرار. هذا النوع من النصوص يُقارب النقّ في كونه كشفًا لزيف الكلام الرسمي، للتظاهر بالقوة، وللروع الذي تحاول السلطة فرضه.
2. الروائية نسرين النقوزي
1 روايتها "المنكوح" تتناول التهميش، الإفقار، زيف المجتمع، الاستلاب الاجتماعي والاقتصادي؛ وهي تقدّم نقدًا اجتماعيًا من زاوية الفرد المعانٍ داخل أنظمة اجتماعية أقوى منه. هذا يركّب “النقّ” اليومي – ليس فقط التذمّر، بل حالة الوعي التي تنتجها المعاناة.
3. منير يونس
1 في مقالة “قلّن إنّك لبناني” ينتقد سخرة اللبنانيين من عجزهم في مواجهة الواقع، من ثقافة “اللي بيحكي يعرف أكتر من اللي بيعمل”، من النقّ الذي يتحوّل إلى نوع من الزهو بالشكوى أكثر من السعي لحلّ.
2 استخدامه للسخرية، للقصص اليومية، ولغة الناس العاديين يعطي بعدًا واقعيًا لظاهرة النقّ في المقاهي، في العائلة، في الشارع.
كيف تُمثّل هؤلاء الأسماء تجلّيات “النقّ” في فضاءات مختلفة
• في الصحافة والمقالات: حازم صاغية، علي غريب، فؤاد مطر — هؤلاء يوجّهون نقدًا مباشرًا للمؤسسات، الخطاب السياسي، اللغة الإعلامية، وطرح الأسئلة التي كثيرًا ما تُهمش في “الخطاب الرسمي”.
• في النقد الأدبي والثقافي: ماودي بيطار، عبده وازن — عبر تحليل النصوص الأدبية، يعكسون كيف تعكس الأعمال الأدبية “نقًّا داخليًا” أو احتجاجًا على الواقع الاجتماعي والثقافي.
• في التعبير الذاتي والهجائي: سمير عطا الله يستخدم السخرية كأداة نقد، ليجعل القارئ يبتسم قبل أن يُفكّر في حالة التناقض التي يعيشها المجتمع اللبناني.
• في الأدب الشامل والرواية: إلياس خوري يُمثّل نقطة التقاء بين الفن والنقد، فالرواية عنده ليست هروبًا من الواقع، بل فضاء مواجهة، تسجيل الذاكرة، والحوار مع الوجع.
الأبعاد النفسية والاجتماعية والسياسية لثقافة النق
• البعد النفسي: التذمّر يُخفّف الضغط الداخلي، الإحباط، الشعور بالذنب أو الخيانة أو الخذلان؛ يُعتبر نوعًا من التفريغ النفسي.
• البعد الاجتماعي: يصبح تفاعلًا اجتماعيًا — النق يجمع الناس على مشترك: “نحن كلنا نعاني”. يعطي شعورًا بالتضامن ولو مؤقتًا.
• البعد السياسي: النق يُستخدم كأداة للضغط الشعبي أو لإبراز الفشل، لكنه في كثير من الأحيان يبقى سقفًا منخفضًا: كلمات على الشاشة، مقالات، لا نتائج ملموسة.
• البعد الثقافي: جزء من الثقافة الإعلامية الشعبية؛ يتحوّل النقّ إلى ما يشبه النمط: عند الانقطاع الكهربائي يُفتح المسلسل "النق"، وعند الغلاء "النق"، وعند التدهور الصحي "النق" … وهكذا يشكل سياقًا يوميًّا.
الأضرار – لماذا "النق" وحده لا يكفي
• يوسّع من دائرة التشاؤم واليأس، وربما يربي ثقافة اللاعمل أو الاعتماد على النقد بدلاً من العمل أو المبادرة.
• قد يُستغل سياسياً: السياسيون والممسكون بالسلطة يستفيدون من النقّ لإظهار أنهم من “جانب المعارضة” أو من الذين يرفضون الوضع، دون أن يقدموا حلولًا.
• يصل الأمر إلى أن يصبح "فنّ النقّ" مهارة؛ قد يُصبح مقياسًا معياريًّا لجودة المواطن – من "يفعّل صوته" أو "ينقّ بشكلٍ صاخب" – بدلاً من أن يكون سؤال: من يفعل؟ كيف يُصلح؟
• الشعور بالإرهاق: إن عادت المطالب بلا استجابة، الناس قد تتوقف، تستسلم، أو تستبدل النقّ بالسخرية أو اليأس أو الانعزال.
أمور إيجابية: هل في "نق" من خير؟
• النقّ يدلّ على وعي؛ الأشخاص لا يقبلون بالواقع، يسعون للتعبير؛ هذا أفضل من التردّي أو السكوت.
• يمكن أن يكون النقّ دفعة أولى نحو الحراك الجماعي، نحو التغيير، إن ارتبط بمطالب واضحة وبإجراءات منظمة.
• فرص للتعبير الحر: المؤسّسات الإعلامية والمجتمعية تستطيع أن تستخدم النق كمرآة لاحتياجات الناس، وتخريج حلولا أو تنبيهات مهمة.
• يُمكن أن ينشّط النق تصوّر بدائل، أو إنعاش النقاش العام والتفكير المجتمعي حول ما يمكن تغييره وكيف.
بدائل ممكنة لثقافة النقّ الشامل
لكيلا يبقى "النق" مجرد صوت دون فعل، من الممكن اقتراح:
1. تحديد مطالب واضحة ومتابعة مؤسساتية: النقّ مع مطلب واضح، توقيع، لجوء لمحكمة، وزارة، إلخ.
2. المشاركة المجتمعية: الجمعيات الأهلية، المبادرات الشعبية، اللجان المحلية — أن تأخذ دورًا قياديًا في اقتراح الحلول وتنفيذها.
3. محاسبة مسؤولة: ليس فقط التنديد، بل مطالبة بمساءلة: “من المسؤول؟” وكيف يُعالج الموضوع؟”
4. لغة بنّاءة: النقد قد يكون بناءً، مع مقترحات، مع فهم للتعقيدات، لا مجرد “شتائم أو استعراض ألم”.
5. تعزيز الثقافة القانونية وحقوق الإنسان: حين يعرف الناس حقوقهم القانونية، يصبح النقّ أقل غموضًا وأكثر توجها نحو المطالب الواقعية.
6. المتابعة الإعلامية الحقيقية: الصحافة قد تتابع من يقدم الوعود، وتقارن القول بالفعل. الإعلام لا يكتفي بإظهار النقّ بل يراقب ما يحدث بعده.
آراء لبعض الشخصيات مهمّة
• غادة شريم (وزيرة مهجّرين سابقًا) قالت: "النق لا يكفي"؛ أي أن التذمّر وحده لا يحقق شيئًا، بل المطلوب أفكارًا وحلولًا عملية للخروج من الأزمة.
• في مقالة “ليس محلاً لبيع «النوفوتيه».. لبنان بين "النق" و"واو الجماعة"” بصحيفة الجمهورية، يشير الكاتب إلى أن النقّ باتَ “ثقافة ملازمة” لحياتنا اليومية وأنه لا يصاحب هذا الصوت غالبًا عمل أو تغيير حقيقي، بل إنه يتحوّل إلى شعار يُرفع فقط.
• في وزارة الإعلام اللبنانية مقال “الإعلام في لبنان: ثقافة حقوقية أم شريعة غاب؟” يقول إن الإعلام غالبًا يعرض النقّ كعرض بصوتٍ عالٍ، بدون أن يُنسب المسؤول القانوني، أو يعطينا مرجعية للمساءلة أو إطاراً حقوقياً واضحًا.
"الثقافة النقّية" في لبنان ليست مجرد ظاهرة سلبية فحسب؛ إنها تعبير عن جرح، عن ألم، عن إحباط متعدد الأبعاد؛ لكنها أيضًا رسالة، دعوة ربما للتغيير، فرصة للتعبير. لكنها تحتاج أن تكون مصحوبة بالإرادة، بالمساءلة، وبالحلول، حتى لا تبقى تكرارًا لليأس نفسه.
توضح كيف “النقّ” مش بس كلام، إنما جزء من الإبداع والثقافة. هي بعض الأمثلة على روايات، كتب، أغاني وغيرها، مع شرح لكل منها:
أمثلة أدبية
1. "حكاية زهرة" – حنان الشيخ
هذه الرواية تصوّر تجربة امرأة لبنانية تواجه العنف، الوحدة، والخيبة في سياق الحرب والأزمات الاجتماعية. فيها صوت داخلي يعكس النقّ النفسي والاجتماعي، والإحساس بأن الواقع مؤلم ومتمدد.
2. "لعنة لبنان" – محمد أبي سمرا
كتاب أحدث (روائي وصحافي) ينكّأ الجرح القديم اللبناني، بين التوثيق والتحليل السياسي والسردي. الكتاب يحاول أن يفهم كيف تترابط الأزمات — السياسية، الاجتماعية، النفسية — وكيف أن شيئاً من النقّ هو محاولة لفهم الذات والهوية.
3. مجموعات قصصية مثل "حكايا لبنانية في الأزمة"
هذا المشروع يجمع عدة كتابات قصيرة تعبّر عن تجارب يومية خلال الأزمات المتعددة: الأزمة الصحية (كورونا)، الأزمات المعيشية، الانهيار الاقتصادي. الكتاب يعطي وجوهاً متعددة للنقّ، ليس فقط الانتقاد، بل سردٌ فرديّ لماذا يعاني الناس وكيف يرون ما حولهم.
4. روايات تختزل الهلاك الإنساني: حروب واعتراض وصراع البقاء
مقالة تتحدّث عن عشر روايات لبنانية تميل إلى ذات المواضيع: الحرب، الفساد، العدم، الفقر، الشعور بالضياع. هذه الروايات غالباً ما تكون مرايا للمجتمع اللبناني في لحظات الفشل والانهيار.
أمثلة فنية / موسيقية
1. فرق مثل “Meen”
فرقة لبنانية تغنّي باللهجة اللبنانية، وتُعرف بأسلوبها الساخِر والنقدي. تُستخدم كلمات بسيطة، نبرة نقدية للمجتمع والسياسة، تجسد النقّ لكن بروح فنية تُشِرك الجمهور في الضحك أولاً، ثم يُفكّر.
2. أغاني قديمة تمس الواقع الحالي
هناك مقالات تجمع أغاني من الزمن الماضي، كلماتها اليوم "تنطبق" على الأزمات الحالية: عن البطالة، غلاء المعيشة، صعوبة التنقل أو انقطاع الخدمات، الحنين لزمن أفضل. مثلاً: أغنية "صارت سنة الألفين" لغسان الرحباني تُستذكر اليوم لأنها "تحكي" كثيراً من آلام الناس التي عادت نفسها.
3. تجربة عائلة لبنانية تغنّي الواقع
في فيديو عائلي منشور على فيسبوك، عائلة “دكاش” غنّوا كلمات تعبّر عن معاناة يومية: أزمة البنزين، انقطاع حليب الأطفال. الفيديو صار رمز بلسان حال الكثيرين، لأن الكلمات بسيطة لكن التعبير صادق.
كيف تساعد الأمثلة في فهم "النقّ" كجزء من الهوية
• الأمثلة الأدبية والفنية لا تكتفي بأن تقول "الوضع سيّئ"، بل تغوص في الألم الداخلي، الفردي والجماعي، وترسم صوراً تجعل القارئ أو المستمع يعيش الحالة.
• تستخدم اللغة المحلية، لهجة، صور مألوفة، حتى لو الرمزية موجودة، فبتقرب أكثر.
• تفتح المجال للحوار: الناس تشوف قصتها أو تسمع أغنية تحس إنها "معيّنة"، فيتساءل: "ليش هذا الشي عم يصير؟"، "شو الحل؟".
• بعض الأعمال تُنشر أو تُعرض في فترات الاحتجاجات أو الأزمات، فتكون بمثابة مرايا ومقاومة، ليست فقط بالنقد، بل في إحياء اللغة والذكرى والكرامة.