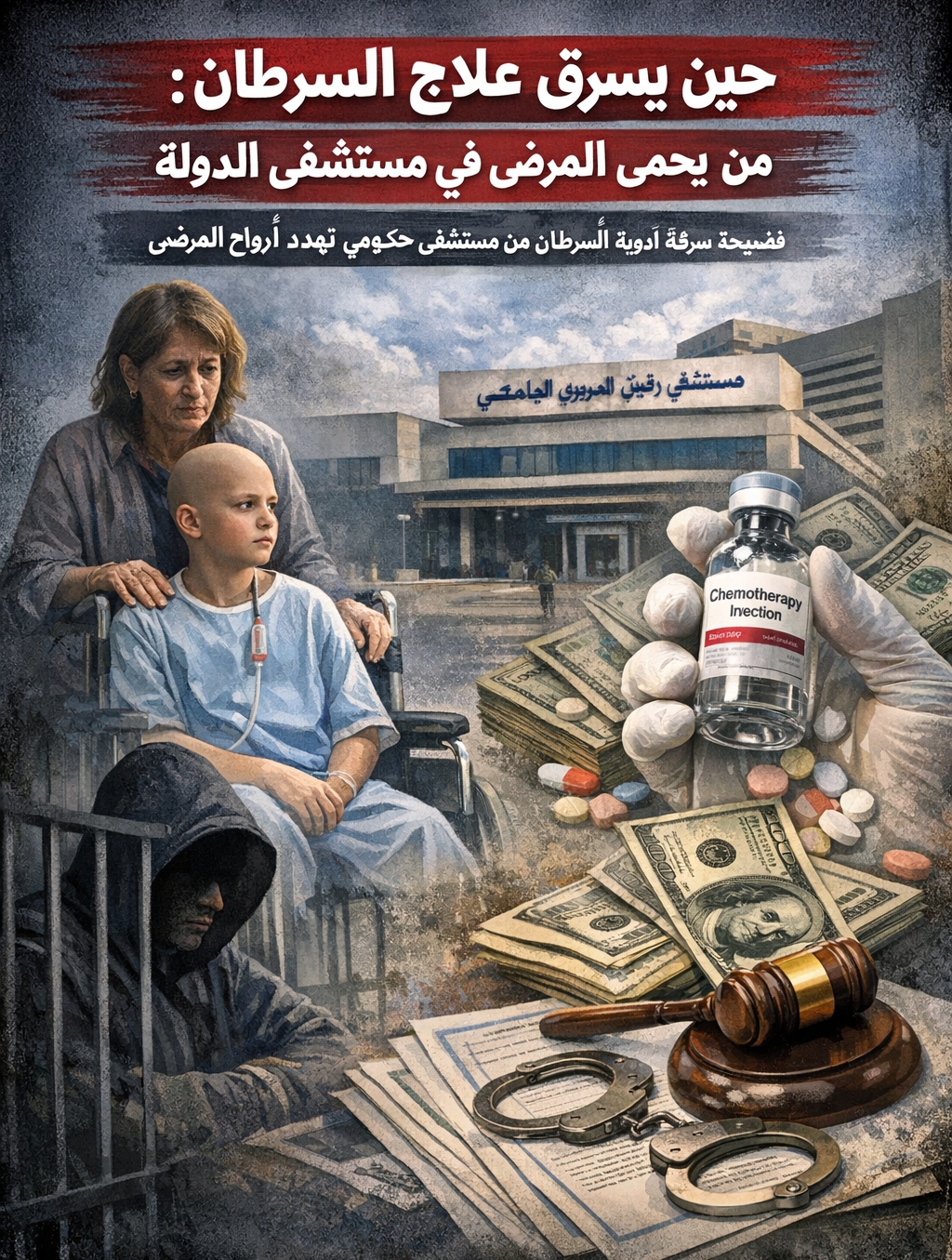إذا كان «الفريق السيادي» متورطاً في ما هو أكثر خطورة على لبنان، ويبدو أكثر انصياعاً للطلبات الأميركية التي تغطي عملياً مطالب إسرائيل، فإن السؤال يصبح ملحّاً للفريق الآخر، خصوصاً القوى التي تواجه الوصاية الجديدة على لبنان، وهي خطوة يفترض أن لديها تمثيلها النيابي من جهة، وبعضها له حضوره داخل الحكومة أيضاً. وحتى لا يبقى الكلام عاماً، فإن الحديث عن ملف ترسيم الحدود البحرية، يخص حزب الله وحركة أمل داخل الحكومة نفسها، كما يخصهما ويخص معهما التيار الوطني الحر وآخرين في مجلس النواب.
إذ لم يفهم سبب عدم إعلان مواقف واضحة للجمهور من القضية، خصوصاً أن مجلس الوزراء أقر خلال ساعة نقاش واحدة، بقرار سوف يقود إلى خسارة كبيرة للبنان في حقوقه بالمياه الاقتصادية، ولكن، يمكن استدراك الأمر عبر العمل في المجلس النيابي.
وإذا كان مجلس الوزراء أمس، قد وافق من دون أخذ وقته لدرس الملف، فإن الجهات المتابعة والمتخصصة أوردت ملاحظات جدية على ما حصل. وقد تحدّث مصدر واسع الاطلاع لـ«الأخبار» عمّا جرى.
يقول المصدر «إن المعركة مستمرة. ولا تكفي موافقة الحكومة، لأن المهم إبرامها في مجلس النواب. وهذا ما يوجب على الجميع التحرك سريعاً». وبحسب المصدر، فإن العرضَين اللذين قدّمهما الخبيران مازن بصبوص ونجيب مسيحي «يعكسان محاولةً لتبرير الاكتفاء بالخط المتوسط المعتمد عام 2007، والقول بعدم وجود ظروف خاصة بين لبنان وقبرص تستدعي تعديل هذا الخط».
من وجهة نظر المصدر، إنّ سياق الملاحظات يتعلق بالآتي:
«من منظور القانون الدولي والاجتهاد القضائي، هناك ثغرات قانونية ومنهجية منها:
- يُقدّم العرضان مبدأ equity (الإنصاف) كما لو كان مبدأً شكلياً لا يتجاوز التحقق من توازن المسافات، ويعتبران أن الاختلاف بنسبة 1 إلى 1.8 في طول الساحلين بين لبنان وقبرص غير كافٍ لتبرير تعديل خط الوسط. لكنّ هذا الطرح يتعارض مع نص المادتين 74 و83 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)، اللتين تنصان على أن الترسيم يتم “بغية التوصّل إلى حل منصف”، لا إلى خطٍ متساوٍ رياضياً. لأن الإنصاف في فقه المحكمة لا يقتصر على مقارنة الأطوال، بل يشمل الظروف الجغرافية والسيادية والاقتصادية، ومنها الطبيعة القارية مقابل الجزيرة؛ الامتداد الطبيعي للجرف القاري؛ مدى السيطرة الفعلية والسيادة القانونية؛ أثر الجزر أو المناطق الأجنبية في الحساب؛ والتناسب بين طول الساحل والمساحة البحرية الناتجة».
وبحسب المصدر، فإن «استبعاد الظروف الخاصة كما فعل العرضان يفرغ مبدأ الإنصاف من مضمونه ويجعل الترسيم عملية هندسية بحتة، وهو ما رفضته محكمة العدل الدولية منذ قضية North Sea Continental Shelf (1969). واستندت الشرائح إلى مقارنة ميكانيكية بين طول الساحلين (188 كلم للبنان مقابل 103 كلم لقبرص)، مستندةً إلى اجتهاد Romania v. Ukraine (2009) حيث رأت المحكمة أن نسبة 1:2.8 لم تستدعِ تعديل الخط».
ويضيف المصدر أن «هذا القياس خاطئ في القياس والمفهوم نظراً إلى تجارب أخرى:
1. في قضية Romania v. Ukraine، كانت الدولتان متقابلتين بحدود متداخلة داخل حوض مغلق (البحر الأسود)، بينما لبنان وقبرص بينهما بحر مفتوح وجزيرة صغيرة في مواجهة دولة قارية.
2. النسبة 1:1.8 لا تُقرأ رياضياً، بل تُقدّر بحسب تأثير طول الساحل على الامتداد البحري الفعلي (effective coastal projection).
3. المحكمة في قضايا Libya/Malta (1985) وBangladesh/Myanmar (2012) اعتبرت أنّ حتى نسباً صغيرة في طول السواحل يمكن أن تُعدَّ ظروفاً خاصة إذا أدّت إلى اختلال ملحوظ في توزيع المساحات».
وفي رأي المصدر الخبير، إن «اختزال الظروف الخاصة إلى فروقات طول الساحل وحدها يُعدّ مغالطة منهجية. إذ لم يتطرّق العرضان إلى أن القاعدتين البريطانيتين (أكروتيري وذكيليا) هما أراضٍ ذات سيادة بريطانية مستقلة بموجب معاهدة 1960، ولا يجوز احتسابهما ضمن الخط الساحلي القبرصي لأي ترسيم.
كما إن الحكومة القبرصية لا تسيطر على كامل أراضي الجزيرة؛ وهو انقسام له أثر مباشر على شرعية أي اتفاق بحري. وبالتالي إن الاعتراف الدولي بسيادة قبرص على كامل الجزيرة ليس مطلقاً في المسائل البحرية، إذ ترفض تركيا والكيان التركي الشمالي الاعتراف بحدودها البحرية. وهي عناصر تشكّل ظروفاً خاصة بامتياز في مفهوم القانون الدولي، وكان يفترض أن تُذكر في أي تقييم علمي للترسيم، ولكنها غابت كلياً عن العرضين.
وبذلك، فإن تجاهلها يُضعف الاستنتاج القائل بعدم وجود “circumstances relevant”.
ويشير المصدر إلى أنه في «كثير من الاقتباسات الواردة من قضايا Libya/Malta, Romania/Ukraine, Nicaragua/Colombia وGreenland/Jan Mayen، أُدرجت في الشرائح خارج سياقها. لأن قضية ليبيا/مالطا (1985) لم ترفض تعديل الخط، بل عدّلته فعلاً لصالح ليبيا، مؤكدة أن الجزر لا تُمنح وزناً كاملاً. كما إن قضية نيكاراغوا/كولومبيا (2012) استخدمت مبدأ “اختبار التناسب” (proportionality test) وأعادت النظر في الخط الأوسط بعد موازنة الأطوال والمساحات. أما في قضية الدنمارك/النروج (1993)، فليست مثالاً صالحاً، لأن الدولتين كانتا داخل بحر شبه مغلق ومتشابهتان في الطبيعة الجغرافية».
ويقول: «إن اجتهادات المحكمة تؤكد، لا تنفي، إمكانية تعديل الخط المتوسط متى وُجدت عوامل خاصة، وهو عكس ما يحاول العرضان إقناعه به. كما لم يُشر العرضان إلى مبدأ natural prolongation الذي يمثل قاعدة محورية في فقه المحكمة منذ 1969. فالجرف القاري اللبناني يمتد جيولوجياً نحو الغرب بانتظام حتى الأعماق المقابلة لقبرص، بينما الجرف القبرصي ينحدر بسرعة نحو الجنوب. وهذا الامتداد الجيولوجي هو حق طبيعي للبنان، ويُعدّ من أبرز “الظروف الخاصة” التي يجب أن تؤخذ في الحسبان، كما ورد في قضيتي North Sea Continental Shelf وLibya/Malta. وبالتالي إن الإصرار على أن لبنان «حصّل أكثر مما يستحق» علمياً يناقض الدراسات الجيومورفولوجية التي تبيّن أن الامتداد القاري اللبناني أكبر بكثير من مساحة الخط المتوسط الممنوحة».
وبحسب المصدر، فإنّ العرضين «تجاهلا أي ترسيم لا يمكن أن يكون منعزلاً عن البيئة الجيوسياسية، حيث لبنان يحاذي منطقة نزاع مفتوحة مع فلسطين المحتلة جنوباً، كما إن اتفاق قبرص–إسرائيل (2010) تجاوز النقطة اللبنانية الرقم (1)، مخالفاً المادة 74 من UNCLOS، ومع ذلك، لم يناقش العرض هذا الانتهاك، بل افترض أن التزام قبرص بخط 2011 كافٍ».
وبحسب المصدر، فإن «العروض تتعامل مع الترسيم وكأنه عملية فنية بحتة، في حين أن القانون الدولي يجعل السيادة الفعلية والاتفاقات مع الغير جزءاً من تقييم العدالة. حيث يخلص العرض الأول إلى التساؤل: “هل يحق تعديل المرسوم 6433 بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إيداعه؟“ ويجيب بأن المادة الثالثة تسمح بذلك “عند توافر بيانات أدق”. لكنّه يحصر الحق في المراجعة بالتقنية الهيدروغرافية، متجاهلاً أن المادة نفسها تتيح التعديل “وفق الحاجة وفي ضوء المفاوضات مع دول الجوار”.
ما يعني عملياً أن الحق في المراجعة ليس تقنياً فحسب، بل سيادي تفاوضي، ويشمل الاتجاهات: شمالاً وجنوباً وغرباً. كما يُظهر العرض الأول مقارنة تقول إن الترسيم مع قبرص “جاء لصالح لبنان” لأن تقرير UKHO البريطاني عام 2011 لم يوصِ بتوسيع حقوق لبنان غرباً».
ويلفت المصدر إلى أن «التقرير كان تقنياً ومبنياً على معطيات تلك المرحلة، ولم يدرس أثر القاعدتين البريطانيتين ولا الوضع القانوني لقبرص. وبالتالي لا يمكن اعتماده كمرجع قانوني حاسم، خصوصاً بعد تطور الاجتهادات الدولية خلال العقد الأخير. كما إن الترسيم البحري لا يهدف إلى تحديد مسافة فقط، بل إلى توزيع الموارد الاقتصادية بعدل».
وبحسب المصدر، فإن العروض «لم تتطرّق إلى حقول الغاز المشتركة (مثل بلوك 12) أو إلى الامتداد الجيولوجي الموحد بين الحوض اللبناني والحوض القبرصي. وفي المقابل، فإن الاجتهاد الدولي (قضية Bangladesh/Myanmar) شدّد على ضرورة مراعاة “الظروف الاقتصادية الخاصة” إذا أثّرت على العدالة. ويُعدّ إغفال هذه النقطة ضعفاً في التحليل، لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة تُعرّف أساساً على أساس الموارد، لا المسافات».
من جهة ثانية، يقول المصدر إن «العرضين يُقدّمان موقفاً دفاعياً يهدف إلى تثبيت الخط القائم عام 2007، ولكنهما يتجاهلان مجمل التطور في فقه القانون الدولي للبحار، ويتعاملان مع مفهوم العدالة كمفهوم هندسي، لا كمعيار سيادي وجيولوجي وسياسي متكامل. وعليه، فإن القول بعدم وجود “ظروف خاصة” بين لبنان وقبرص يتعارض مع الواقع القانوني والسيادي، ومع المبادئ التي أرستها محكمة العدل الدولية منذ أكثر من نصف قرن، بدءاً من North Sea Continental Shelf وصولاً إلى Bangladesh/Myanmar».
ويخلص المصدر إلى «أن الاستنتاج المنهجي هو أن لبنان يمتلك حججاً قانونية قوية لتعديل خط 2007 باتجاه الغرب، استناداً إلى الامتداد الطبيعي لجرفه القاري، واستبعاد القاعدتين البريطانيتين، وعدم اكتمال سيادة قبرص، وهو ما يجعل إعادة الترسيم ضرورة قانونية لا مغامرة تفاوضية».