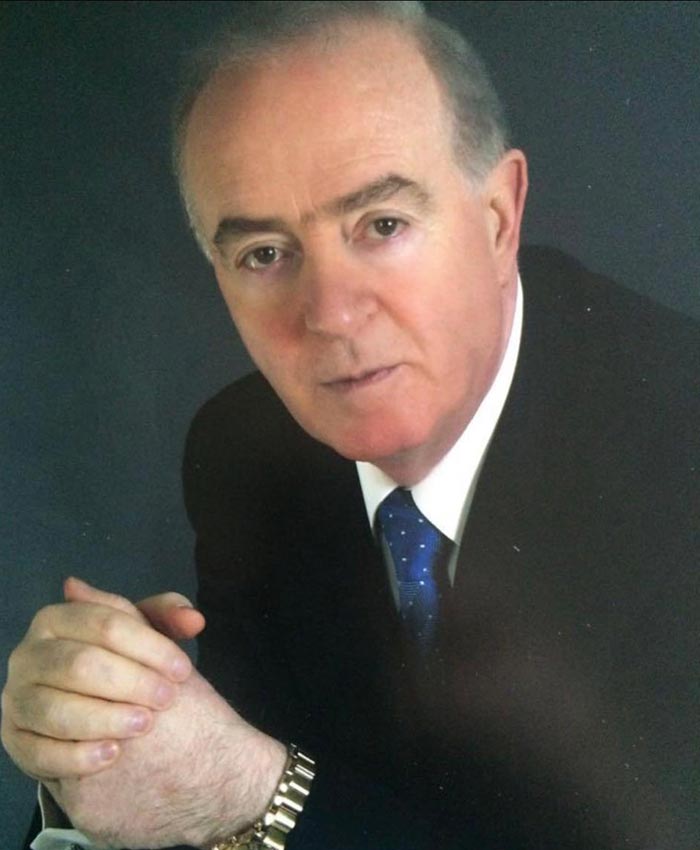خاص - ايست نيوز
تواصل المصارف اللبنانية، منذ انهيار عام 2019، إدارة الأزمة بعقلية العصابة لا بعقلية القطاع المالي. لم تُخطئ الحسابات فقط، ولم تسقط السياسات النقدية من تلقاء نفسها، بل جرى الاستيلاء المنهجي على أموال الناس، وفرضت قيود تعسفية على الودائع من دون أي أساس قانوني، ثم تُرك المودعون لمصيرهم تحت شعارات الصبر و«المرحلة الاستثنائية». واليوم، وبعد سنوات من الإنكار، تعود المصارف إلى واجهة المشهد بوقاحة غير مسبوقة، مسوّقةً «سلعاً مالية جديدة» في بلد لا يزال غارقاً في الانهيار.
سرقت الودائع في وضح النهار، ثم جرى تذويب قيمتها عبر أسعار صرف متعددة واقتطاعات مقنّعة، ومنع الناس من التصرّف بأموالهم كأنها لم تعد ملكهم. ومع ذلك، لم نسمع اعترافاً واحداً بالمسؤولية، ولا رأينا محاسبة جدية، ولا لمسنا أي مبادرة لإعادة الحقوق. بدل ذلك، اختارت المصارف الانتقال إلى مرحلة أخطر: إعادة تدوير الجريمة نفسها بواجهات أكثر حداثة.
تغرق المصارف السوق اليوم بعروض بطاقات دفع متنوعة: مسبقة الدفع، «دولارية»، افتراضية، ومحافظ إلكترونية، تُقدَّم كأنها دليل تحديث وتعافٍ. لكن هذه البطاقات، في واقع الأمر، ليست أكثر من قيود جديدة على أموال مسروقة. بطاقة تُحدَّد سقوفها وشروطها بإرادة المصرف، ومن دون أي ضمانة تشريعية أو رقابية حقيقية، وتُستخدم كوسيلة لضبط ما تبقّى من السيولة وإبقائها تحت السيطرة.
يُطلب من المودع، الذي حُرم من ودائعه لسنوات، أن يثق مجدداً بالمصرف نفسه، وأن يتعامل مع منتجات لا تعيد له حقه، بل تنظّم حرمانه منه. فبدلاً من السؤال الجوهري: أين ذهبت الودائع؟ يجري إغراق الناس بأسئلة تقنية عن نوع البطاقة وحدّها الأقصى ورسومها، في محاولة مكشوفة لتحويل الأنظار عن أصل الجريمة.
من الناحية القانونية، لا يمكن توصيف ما حصل منذ 2019 إلا كاستيلاء غير مشروع على الملكية الخاصة. فالدستور اللبناني يحمي حق الملكية، وقانون الموجبات والعقود يضمن حق المودع في التصرّف بوديعته عند الطلب. ومع ذلك، فرضت المصارف قيوداً شاملة بقرارات داخلية، من دون أي قانون صادر عن مجلس النواب، ومن دون إعلان حالة طوارئ مالية أو آلية استثنائية مشروعة.
الأخطر أن السلطات السياسية والنقدية لم تكتفِ بعدم المحاسبة، بل وفّرت الغطاء الكامل لهذا السلوك. فحتى اليوم، لم يُقرّ قانون كابيتال كونترول عادل وشامل يحدّد المسؤوليات ويحمي صغار المودعين، بل جرى الاكتفاء بإدارة الفوضى، وترك المصارف تفرض قواعدها الخاصة.
على مدى السنوات الماضية، سمع اللبنانيون عشرات التصريحات الرسمية التي أكدت أن الودائع «مقدّسة» و«مضمونة»، وأن الدولة لن تسمح بضياع أموال الناس. لكن هذه التصريحات بقيت مجرّد خطابات للاستهلاك الإعلامي، في وقت استمر فيه النزف اليومي للودائع، وتراكمت الخسائر على حساب المودعين وحدهم.
واليوم، بدل ترجمة تلك الوعود إلى أفعال، يجري التحضير لتشريع نهائي للجريمة تحت عنوان مضلّل: «إعادة الانتظام المالي».
مشروع ما يُسمّى «إعادة الانتظام المالي» لا يشكّل خطة تعافٍ بقدر ما يمثّل وثيقة تبرئة. فهو لا ينطلق من مبدأ المحاسبة، ولا يحدّد بوضوح مسؤوليات المصارف ومصرف لبنان والدولة، بل يهدف عملياً إلى شطب جزء كبير من الودائع، وتثبيت الخسائر كما هي، وتحميلها للحلقة الأضعف: المودع والمجتمع.
في هذا السياق، لا يمكن فصل الترويج المحموم لبطاقات الدفع والخدمات الجديدة عن المسار التشريعي الجاري. فالأولى تُستخدم لتلميع الصورة واستدراج التعامل، والثاني لتأمين الغطاء القانوني النهائي. إنها معادلة واضحة: تشريع السرقة من جهة، وتسويقها من جهة أخرى.
لا يمكن لأي قطاع مصرفي أن يستعيد دوره الطبيعي من دون إعادة الودائع أو وضع آلية عادلة وشفافة لتوزيع الخسائر تبدأ من رساميل المصارف وأرباحها وتحميل كبار المستفيدين مسؤولياتهم. أما القفز فوق هذه الحقائق، والانتقال مباشرة إلى بيع «منتجات جديدة»، فليس سوى استكمال للجريمة بأدوات مختلفة.
الثقة لا تُشترى ببطاقة دفع، ولا تُستعاد بتطبيق هاتفي، بل تُبنى بالعدالة والمحاسبة. وكل ما يُطرح خارج هذا الإطار هو احتيال مُقنّع، ومحاولة لاستدراج ضحايا جدد أو إرهاق الضحايا الحاليين حتى الاستسلام.
في الخلاصة، ما تفعله المصارف اللبنانية اليوم ليس تحديثاً مصرفياً ولا إصلاحاً مالياً، بل استمرار لجريمة مفتوحة لم تُقفل بعد. وحين يُسرق المال أولاً، ثم يُطلب من صاحبه أن يصفّق لـ«حل رقمي»، نكون أمام نظام يزداد وقاحة كلما أفلت من المحاسبة، ويؤكد أن معركته الحقيقية ليست مع الانهيار، بل مع حقوق الناس.